نحو الوصاية العسكرية!!!
د. أكرم حجازي
بخلاف النظام الدولي، وحتى بعض مضي نحو ثمانية عشر شهرا على الثورة السورية، إلا أن السوريين لم يتجرؤوا بعد على مواجهة لحظة الحقيقة العاصفة في مسار الثورة وما بعدها. ففيما خلا الجماعات الجهادية، ذات المنحى العقدي في خوض الصراع وإدارته، فإن بعض البقية الباقية، والغالبية من القوى السياسية والمقاتلة، (1) يتمنع أو يتردد أو يتهرب خشية من استحقاقات اللحظة القادمة، لا محالة، وبعضها الآخر (2) ما زال يتأمل الخلاص عبر تدخل دولي يختصر الوقت والجهد، ويعفيه من الحرج، وبعضها (3) لم يتردد، منذ اللحظة الأولى للثورة، في نسج تحالفات واتصالات مع القوى الدولية، غير آبهٍ بأية عواقب عقدية أو حقائق تاريخية وموضوعية أو حتى أخلاقية تجاه خياراته. والسؤال: أين عين الحقيقة في الثورة؟
أولا: قبل تنحي الأسد
عين الحقيقة ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد، حين سئل بعد الثورة التونسية والمصرية، عما إذا كان من الممكن أن تندلع ثورة في بلاده فأجاب بالنفي، مشيرا إلى أن « سوريا مختلفة»!!! ولما وقعت الثورة هدد بـ « إشعال الشرق الأوسط في ست ساعات»، وفي مقابلة عاصفة مع صحيفة « الصندي التلغراف – 30/10/2011 » البريطانية، ذكّر الأسد « المركز» بالواقع الذي لم يختلف عليه أحد منذ تم اختيار الطائفة العلوية لتكون الأمينة على النظام الدولي وأمن المنطقة، فقال:
« إن سوريا اليوم هي مركز المنطقة .. سوريا مختلفة كل الاختلاف عن مصر وتونس واليمن. التاريخ مختلف، والواقع السياسي مختلف .. إنها الفالق الذي إذا لعبتم به تتسببون بزلزال، .. هل تريدون رؤية أفغانستان أخرى أو العشرات من أفغانستان؟ .. أي مشكلة في سوريا ستحرق المنطقة بأسرها .. إذا كان المشروع هو تقسيم سوريا، فهذا يعني تقسيم المنطقة برمتها …».
لم يكن الأسد غبيا ولا مبالغا حين اختار أن يكون الحوار مع المركز هو « عين الحقيقة». فالشام هي أرض الخلافة وذات الكفالة الربانية وملاذ المؤمنين في زمن الفتن والملاحم وأرض المحشر والمنشر. وانفكاك أسرها يعني زلازل في المنطقة والعالم وليس زلزالا واحدا.
عين الحقيقة في التسليم بالقول: لو أن نظاما ما تعرض لهزة واحدة كالتي يتعرض لها النظام في سوريا لسقط على الفور. ومع ذلك فقد اندلعت ثورة من رحم المستحيل، ولم يعد فيها للنظام جيشا آمنا ولا جهازا أمنيا ولا قائدا، وخسر قادة ما يسمى بـ « بخلية الأزمة»، علاوة على خسارته لأكثر من 70% من سيطرته على الأرض، وبدأ السياسيون، كالعسكريين، يبحثون عن هوامش للإفلات من قبضة النظام، حتى أن شخصية بحجم رئيس الحكومة لم تعد شخصية مأمونة، فضلا عن نائب الرئيس .. ومع أن النظام يتعرض في صلبه لاستنزاف مرعب في عناصر القوة لديه إلا أنه ما زال يبدو نظاما قويا وعصيا على الكسر!!! فمن أين له كل هذه القوة!!!؟ سؤال في « عين الحقيقة»!!!
عين الحقيقة هو ما ينبغي التسليم به بلا مواربة من أن الطائفة العلوية في سوريا هي امتياز دولي جرى تأهيلها منذ لحظة الانتداب الفرنسي على سوريا كي تؤدي وظيفة واحدة هي امتصاص كافة حركات التحرر والتمرد التي يمكن أن تهدد لاحقا استقرار أو بقاء النظام الدولي الحالي، الذي أقيم على أنقاض العالم الإسلامي من جهة أخرى. ومن يجادل في هذه الحقيقة البديهية عليه يتذكر ما سبق وقاله أمين الحافظ، الرئيس السوري الأسبق، في برنامج شاهد على العصر على قناة « الجزيرة»: « في سوريا نظام حكم طائفي حاقد على كل ما يمت للإسلام والعروبة بصلة»، وعليه فما من طائفة في الشام يمكن ائتمانها على المنطقة والنظام الإقليمي الدولي، الذي مركزه سوريا، كما هي الطائفة العلوية. ولأن بذور البغض والحقد على العروبة والإسلام متأصلة فيها .. ولأنها طائفة مطاريد؛ فقد كانت مهيأة، استعماريا، للقيام بأية مهمة لقاء نزولها عن الجبال، والتمتع بخيرات السهل ( = المدينة). وقد مضت عقود طويلة، منذ الانتداب الفرنسي وإلى يومنا هذا، حالت فيه هذه الطائفة من إحداث أي فارق في الصراع العربي « الإسرائيلي»، ونجحت في تجميد أو تفكيك كل عناصر القوة في الأمة، فضلا عما فعلته على وجه الخصوص في المجتمع السوري من قهر وقتل وتجهيل وعنصرية وإشاعة للفاحشة والظلم والفساد والاستبداد.
ولأن عين الحقيقة تكمن في إدراكها، وإدراك مكانة سوريا في النظام الدولي، فلا مفر من التذكير بأن الروس هم الذين تسلموا حماية الطائفة العلوية من الفرنسيين في أعقاب « حرب السويس» سنة 1956، وهم الذين أوصلوها، فيما بعد، إلى الحكم، وسهروا على رعايتها، إلى أن لحق بهم الإيرانيون بعد 17/2/1982. وبالتالي فإن « المركز» هو المسؤول عن حماية النظام وبقائه في سوريا وليس الروس وحدهم. ولنتأمل ما قاله الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، في مؤتمر صحفي عقده بموسكو 21/6/2012: « من الواضح تماما أن الوضع السوري مرتبط بأسس النظام العالمي المستقبلي، وكيفية تسوية الوضع ستحدد إلى حد كبير كيف سيكون هيكل نظام الأمن الدولي الجديد والوضع في العالم عموما». أما ألكسندر أورلوف، السفير الروسي في باريس (20/7/2012)، فقال: } إن ما تدافع عنه روسيا ليس نظام بشار الأسد، « لكنه النظام الدولي»{. وما يبدو خلافا بين شقي المركز، الشرقي بقيادة روسيا، والغربي بقيادة الولايات المتحدة، ليس في الحقيقة إلا صراعا على النفوذ مصدره العقلية القيصرية الإمبراطورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضعف « الرأسمالية» مقابل صعود الروس والصينيين اقتصاديا. وفي السياق نذكر بالتصريح المثير له حين قال في 11/7/2012: « إن نفوذ الغرب آخذ في الاضمحلال مع تراجع اقتصاده .. وأنه .. مشارك في دبلوماسية منفردة خارج الأمم المتحدة للحفاظ على نفوذه في السياسة العالمية».
لكنه، مع ذلك، يظل صراعا لا يخرج عن خشية الغرب من انهيار مفاجئ للنظام، قد يؤدي إلى كوارث على النظام الدولي، مقابل اعتراضات روسية وصينية تجهد في توظيفه لخدمة مصالحها والاستئثار بمكانة أعلى في النظام الدولي، إنْ لم يكن السعي لقيادته. وبالتالي ينبغي أن يُفهَم جيدا أن اعتراضات الروس والصينيين لمساعي الغرب في مجلس الأمن الدولي لا تمت بصلة، من قريب أو من بعيد، لنصرة الشعب السوري أبدا، هذا الفهم هو « عين الحقيقة» أيضا فيما يتعلق بدعوات بعض قادة الحزب الجمهوري الأمريكي لتسليح الثوار السوريين أو التحريض على التدخل العسكري الأمريكي بزعم الحرص على مصداقية القيم الأمريكية!!! فهي دعوات لا تخرج عن نطاق الاجتهاد في اعتراض السياسات الروسية أو تأمين خط الرجعة للسياسات الأمريكية في قادم الأيام أو الأسابيع أو حتى السنين.
عين الحقيقة فيما لا يمكن للعين أن تخطئه من أن الثورة السورية تحاصرها ثلاثة مشاريع عقدية دولية ضارية هي « صليبية المركز» و « صفوية إيران» و « يهودية إسرائيل». والكل فيها يتسلح ويصنع وينتج ويهاجم ويتمدد على حساب المسلمين الذين لا يمتلكون حتى الآن مشروعا عقديا صريحا تجتمع عليه الأمة دون وجل من هذه القوة أو تلك. وغني عن القول أن أصحاب هذه المشاريع أباحوا لشعوبهم ودولهم السعي لامتلاك كل أدوات القوة واستعمالها في الغزو والعدوان والقتال في شتى بقاع الأرض في حين لم يكن لأي مشروع إسلامي من نصيب إلا الإدانة والعدوان والتصفية والتشويه. بل أن « الجهاد» صار حقا لدى ملل الكفر قاطبة ومحرما على ملة الإسلام أن تدافع عن نفسها. وفي المحصلة تبدو الثورة السورية، شاءت أم أبت، في مواجهة صريحة مع النظام الدولي برمته، عاجلا أم آجلا، أو في مواجهة نفسها إذا ما أصرت القوى السياسية على التهرب من هذه الحقيقة أو أنكرتها أو خاصمت أهلها.
ثانيا: بعد التنحي
وعليه فإن عين الحقيقة أيضا تقع في الإقرار بفرضية جدلية تميل إلى القول بأنه حتى لو انشق بشار الأسد نفسه، وأنّى له ذلك، فلن يغير انشقاقه من الأمر شيئً فيما يتعلق بمصير النظام في سورية، باعتباره ملكية دولية. فحتى هذه اللحظة لا يمتلك « المركز» أي بديل عن النظام في سوريا إلا النظام نفسه، أو بمعنى أدق الطائفة نفسها. وهي حقيقة سبق وأكدها رفعت الأسد، في مقابلة مشتركة مع وكالة « فرانس برس» وصحيفة « لوموند – الفرنسية – 14/11/2011»، حين قال بأن: « الحل يكمن في أن تضمن الدول العربية لبشار الأسد سلامته كي يتمكن من الاستقالة وتسليم السلطة لشخص لديه دعم مالي ويؤمن استمرارية جماعة بشار بعد استقالته، يجب أن يكون شخصًا من عائلته: أنا أو سواي». وفي السياق ينبغي إعادة التأكيد الحاسم الذي لا يقبل الجدل على أن النظام في سوريا ليس هو الأسد ولا عائلته بل الطائفة نفسها. وهنا بالضبط تقع تصريحات قدري جميل، نائب رئيس الحكومة السورية، حول إمكانية مناقشة استقالة الأسد في حوار محتمل مع المعارضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (21/8/2012).
عين الحقيقة أن « المركز» الذي عمل على تنصيب الطائفة حاكمة على سوريا يشعر وكأنه يواجه لحظة لم تكن في الحسبان .. لحظة المفاصلة الشعبية الحاسمة مع النظام واحتمال زوال حكم الطائفة. ولأنه لا بديل لديه فلا حل عنده إلا إطالة أمد النزيف الدموي بانتظار التحضير لبديل قادم ليست له أية ملامح حتى الآن إلا النظام نفسه. وبالتالي فهو يعمل منذ بداية الثورة على معادلة « الحل مع النظام» سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد السياسي أو حتى على صعيد تدمير سوريا برمتها حتى لا تقوم لها قائمة لعشرات السنين. وهو حل لا يدرك تبعاته غوغاء الثورة السورية ولا يلقي له ربائب « المركز» بالا.
عين الحقيقة أن « المركز» بات مقتنعا باستحالة استمرار الأسد في السلطة، لذا فقد بدأ الشق الغربي منه، يسابق الزمن لترتيب الوضع في سوريا عبر تكثيف اتصالاته مع (1) القوى الدولية خارج الأمم المتحدة و (2) الاستخبارات الإقليمية و (3) عسكريين منشقين. فمنذ الفيتو الروسي – الصيني الثالث في مجلس الأمن (21/7/2012) أعلنت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية، أن: « الولايات المتحدة ستعمل خارج الأمم المتحدة لدعم المعارضة السورية» في ضوء « الأداء السيئ» لمجلس الأمن. ونشطت الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والبريطانية فعليا في التنسيق لتأمين ما أسموه « انتقالا سلميا للسلطة» و « تأهيل المعارضة السورية»، وتبعا لذلك أعلن كوفي أنان، المبعوث العربي الدولي المشترك، استقالته في 3/8/2012 احتجاجا على تبادل « الاتهامات والسباب» في مجلس الأمن، في حين أن سبب الاستقالة يكمن في نهاية المهمة.
أما على الصعيد الأمني فقد تصاعدت الاتصالات الأمريكية – التركية، تمهيدا لما أسمته هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، بـ « اليوم التالي» قائلة: « أعتقد أننا نستطيع أن نبدأ في الحديث عن والتخطيط لما سيحدث بعد ذلك» .. وقد جرى ترجمة هذا « الاعتقاد» في أعقاب لقائها بنظيرها التركي أحمد داوود أوغلو في اسطنبول (7/8/2012)، فقالت: « نحن بحاجة إلى الخوض في التفاصيل الحقيقية مثل التخطيط العملي ويجب أن يتم ذلك عبر حكومتينا»، وأضافت: إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على التنسيق المشترك والعميق بشأن الحاجة لدعم جماعات المعارضة السورية، وذلك من أجل إعدادها لمرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد». وفي السياق كشفت كلينتون عن: « وحدة أزمة جديدة تشكلت للتعامل مع أسوأ حالة من السيناريوهات بسوريا» مضيفة أن: « أجهزة مخابراتنا وجيشانا أمامهم مسؤوليات مهمة وأدوار عليهم القيام بها ومن ثم سنشكل مجموعة عمل لتحقيق هذا الأمر»، يجيء الإعلان عن « الوحدة» على خلفية الكشف عن « أمر سري» وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقضي بتقديم دعم لوجستي للمعارضة دون الدعم القتالي، ولا ريب أنها ستعمل بالتنسيق مع مركز القيادة السري في أنطاكيا، والذي تديره الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر، لتحديد وجهة الدعم الحيوي لمقاتلي المعارضة، بحيث لا تصل إلى قوى إسلامية معارضة.
ومن عين الحقيقة في السياق أيضا؛ أن الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية ولاسيما الأمريكية، التي تعاني، بحسب صحيفة « الواشنطن بوست – 25/7/2012 » الأمريكية من فجوة استخبارية في سوريا حول هوية القوى العسكرية المقاتلة والنظام السوري، تنشط منذ شهور في بناء شبكة اتصالات مع كبار الضباط المنشقين وحتى في تجنيد العملاء، سواء بهدف المراقبة أو لتحقيق اختراقات في صفوف القوى المقاتلة من الجيش الحر وغيره أو للحصول على معلومات ميدانية وأخرى حساسة تتعلق بمخزون الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري، وتمهيدا لبناء ذراع ضاربة تتولى مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية وضبط السلاح والحدود في حالة رحيل سلس أو مفاجئ للأسد. وفي مقالة له كتبها في صحيفة « التايمز – 10/8/2012 » البريطانية قال وليم هيغ، وزير الخارجية،: « أن بلاده ستواصل العمل مع المعارضة السورية وخصوصا مع ممثلي الجيش الحر لتأمين استعدادهم للسقوط الحتمي للأسد». ولم يكن غريبا أن تتسرب مؤخرا قائمة بأسماء عشرة ضباط منشقين من مناطق درعا والسويداء وريف دمشق وحمص وحماه واللاذقية وإدلب وحلب ودير الزور، قيل أن الأمريكيين التقوا بهم فرادى، بهدف تشكيل أطر عسكرية وأخرى سياسية لاستقطاب رموز القوى في مرحلة أولى كمقدمة لاستقطاب العناصر التي ستنضوي تحت هذه التشكيلات قبل الإعلان عنها.
والعجيب في أمثال هؤلاء أنهم حين يجلسون مع الأمريكيين أو يتم استدعاءهم من قبل المخابرات الدولية يظنون أنهم أندادا لهم، ويمكن أن يعتمدوا عليهم، كقادة مؤهلين، أو خبراء يتمتعون بالكفاءة، في حين أن أمثلهم طريقة سرعان ما يقع في فخ انعدام الوزن، حتى أنه لا يدري الفرق بين السلطة الحاكمة والنظام.
وفي الولايات المتحدة أيضا، وفي ذات السياق من التواصل مع المعارضة أو صناعتها، نقلت وسائل إعلام في 12/8/2012 عن وزيرة الخارجية، بعد لقائها نظيرها التركي،: « أنها التقت مجموعة من الناشطين السوريين والخبراء والقانونيين والصحفيين والقيادات الطلابية في محاولة لمعرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله لمساعدتهم». وفي وقت لاحق 11/8/2012 أُعلن في واشنطن عن تشكيل جماعة سورية معارضة من ستين عضوا باسم « جماعة الدعم السورية»، لجمع التبرعات المالية والعينية، وبحسب لؤي السقا، أحد الأعضاء الاثني عشر في مجلس الإدارة، فإن الجماعة: تمثل آلاف المقاتلين في تسع محافظات، وأن هؤلاء الذين يمثلون ما يقارب نصف المقاتلين في الجيش الحر»، وأنهم: « وقعوا إعلان مبادئ يدعو إلى دولة ديمقراطية لجميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو العرق، وترفض المبادئ كذلك الإرهاب والتطرف والقتل بغرض الانتقام».
أما الأتراك فـ عين الحقيقة واقعون بين المطرقة والسندان. فهم كمجتمع وريث الإمبراطورية العثمانية يعج بعشرات القوميات المختلفة، مثل سوريا تماما، وأكثر ما يؤرقهم في مسألة القوميات أولئك العشرة ملايين علوي أو أكثرممن يعيشون بعمق يصل إلى أضنة، فضلا عن المشكلة الكردية ممثلة بـ « حزب العمال الكردستاني – PKK». أما النفوذ الصهيوني والرأسمالي في البلاد فما زال بالغ القوة. وإذا أضفنا الشيعة إلى هؤلاء؛ فيمكن القول ببساطة أن تركيا تقف على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة غير محسوبة، وأسوأ ما في هذا أن المشروع التركي الذي من المفترض أن تصبح البلاد بموجبه من العشرة الكبار في العالم بحلول العام 2023 يصبح في مهب الريح. لذا فقد تحرك الأتراك على عجل لضمان مصالحهم في المنطقة في حالة سقوط الأسد. وتصرفوا وكأنهم في حالة حرب حين تجاوزوا الأعراف الدبلوماسية بين الدول واجتمعوا بأكراد العراق في كركوك، المدينة التي يُنظر إليها بمثابة الشرارة التي يمكن أن تفجر الأوضاع في العراق بين الأكراد وحكومة المالكي، وبدا أن أكراد العراق قد حصلوا من الأتراك على ما لم يحصلوا عليه من المالكي، مقابل التوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني و « الاتحاد الديمقراطي» في سوريا. وفي المحصلة فإن التعويل على دعم تركي حاسم للثورة السورية بعيدا عن الغطاء الدولي يبدو شبه مستحيل. ولا يفوتنا في السياق التذكير بالتصريح الشهير لوزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لوكالة « أنباء الأناضول – 9/7/2012 » والذي قال فيه: « حاولنا إسقاط النظام في سوريا وفشلنا».
أما الإيرانيون فقد أرسوا بعد « مجزرة حماة – 1982» بنية تحتية أمنية في سوريا، اخترقت كل مفاصل الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكثر من هذا عملوا على تركيز بنية تشيُّع عريضة تبدأ من العاصمة دمشق وتمتد حتى حمص وحماة والرقة وإدلب وحلب. ونسجوا علاقات تحالف مع النظام ترى في سوريا بلدا يحكمه « آل البيت» ولا يمكن أن يسمحوا بسقوطه بأيدي « النواصب» على حد تعبير أحمد جنتي، عضو مجلس الخبراء، الذي قال في خطبة الجمعة بطهران (25/5/2012): « على الشيعة العرب الدخول إلى سوريا والجهاد إلى جوار النظام السوري حتى لا تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت». ثم تبعه محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بالقول: « إن الشعب الإيراني له موقف لا يقبل التغيير إزاء السوريين وسيقف دائما إلى جوارهم»، وكذلك أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الذي قال في 31/7/2012 أن: « طهران مستعدة لدعم دمشق أكثر من ذي قبل في مواجهة الضغوط الأجنبية .. سنقرر وفقا للظروف كيف سنساعد أصدقاءنا والمقاومة في المنطقة». وبعدهم وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي وتأكيده لوكالة « مهر – 22/8/2012 » الإيرانية أن: « اتفاقية الدفاع المشترك بين بلاده وسوريا لا تزال قائمة وسارية المفعول» .. لكن دمشق .. « لم تتقدم حتى الآن بأي طلب يتعلق بهذه الاتفاقية»، وقبله بيوم؛ نقلت صحيفة « الوطن» القريبة من النظام السوري تصريحات إيرانية حذرت فيها تركيا من « رد قاس» .. في حال تدخلها عسكريا في سوريا .. و « تغيير قواعد اللعبة». ومن جانبه نقلت صحيفة « شرق – 31/7/2012 » الإيرانية عن مسعود جزائري، نائب رئيس أركان الجيش الإيراني، قوله أن إيران: « لن تسمح للعدو بالتقدم في سوريا»، لكنها لا ترى ضرورة للتدخل في الوقت الحالي، مضيفا أن: « تقييمنا هو أنهم لن يحتاجوا لذلك».
باختصار فإن المشروع « الصفوي» الإيراني الذي تضخم بالتواطؤ مع « المركز»، وواصل تمدده حتى بلغ أصقاع الأرض لا يرى أية إمكانية للتراجع عما حققه من إنجازات، لاسيما أنه بات أكثر جدوى وفائدة، بالنسبة لـ « المركز» من المشروع « اليهودي»، بالنظر إلى إمكانياته الضخمة وعداءه العقدي مع المسلمين وتوفر القدرة لديه على اختراق الحواضر الإسلامية في العالم الإسلامي بما لا يقارن مع قدرة « إسرائيل»، العدو العقدي الصريح. وإذا كانت الطائفة العلوية تمثل ضمانة أمنية متميزة لعشرات العقود السابقة؛ فمن الأولى القول بأن المشروع « الصفوي» بات أكثر ضمانة لـ « المركز» حتى من المشروع الصهيوني نفسه، وفي هذا يكمن سر التحريض « الإسرائيلي» على ضرب إيران بعد أن شعرت « إسرائيل» أن المشروع « الصفوي» يهدد مكانتها الدولية إنْ لم يهدد وجودها ذاته. فهل يستوي بعد هذا القول بأن إيران أو « المركز» عدوان!!!!؟ أو أن « المركز» يمكن أن يضحي بالمشروع « الصفوي» وهو العاجز عن إيجاد بديل للطائفة الحاكمة في سوريا!!!؟
عين الحقيقة أن « المركز» قد يتدخل عسكريا لكن ليس من أجل إسقاط النظام بل بعد سقوطه. فعشية الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية لتركيا واجتماعها مع نظيرها أحمد داوود أوغلوا قال المسؤولون الأمريكيون أن كلينتون ستجري « محادثات عميقة» لمناقشة خطة من ثلاثة محاور تهدف إلى تنحي الأسد وتحقيق انتقال سلمي للسلطة، (أولها) « تقييم مدى نجاعة الدعم المقدم حاليا للمعارضة السورية»، و (ثانيها) « مضاعفة المساعدات الإنسانية لتركيا لدعم جهودها في مساعدة اللاجئين السوريين»، و (ثالثها) « التخطيط للمرحلة الانتقالية وما بعد التخطيط». وفي ذات الإطار، يؤكد الأمريكيون أنهم: « لا يستطيعون وضع تاريخ محدد لرحيل الأسد، ولا يعرفون متى سيكون هذا ممكنا»!!! وكل ما يفعلونه هو تهيئة: « المجموعة الدولية أن تكون مستعدة لمساعدة السوريين في التعامل مع التحديات التي ستواجههم في الانتقال إلى سوريا الجديدة». لكن ما هو مضمون التدخل المحتمل؟ وما هي دواعيه وأهدافه؟ وماذا يعني بالنسبة للثورة السورية؟
عين الحقيقة أن « المركز» لم يعد قادرا على القيام بمغامرات عسكرية بعد تجارب أفغانستان والعراق على وجه الخصوص. فهو يعلم علم اليقين أن هناك من يتحين الفرصة لخطأ من هذا النوع، ويتحرق لمنازلته كما تحرق الشعب السوري عقودا طويلة شوقا لمنازلة النظام الطائفي. ويعلم أيضا أن الأزمة الرأسمالية الطاحنة في العالم لن تتيح له خيارات كبرى أو حتى صغرى لإرسال الجيوش إلى حيث يرغب، إلى الحد الذي اضطر الولايات المتحدة، بداية هذا العام، إلى تغيير استراتيجيتها القتالية والاعتماد على الحروب الرقمية والأمن والطائرات المسيرة بدلا من الجيوش التي ستستخدم فقط في أضيق الحدود.
لذا فإن الأمريكيون ليسوا متحمسين لأي تدخل في سوريا يسبق رحيل الأسد!! ونقلا عن صحيفة « نيويورك تايمز – 22/8/2012 » الأميركية فقد أوضح مسؤولون أمريكيون أن: « العمليات العسكرية الأميركية ضد سوريا ستهدد بجرّ حلفاء سوريا خصوصا إيران وروسيا، إلى التدخّل أكثر مما كان أصلاً، وستسمح للرئيس بشار الأسد بحشد مشاعر شعبية ضد الغرب وستوجه اهتمام القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى تقاتل النظام السوري إلى ما قد تعتبره حربا صليبية أميركية جديدة في العالم العربي». وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) فإن: « السيناريو الأسوأ سيتطلب مئات الآلاف من الجنود وهو أمر سيشعل المنطقة المشتعلة أكثر».
في تقرير نشرته صحيفة « نيويورك تايمز – 29/7/2012» لمراسلتها في أفغانستان، نقلت أليسا جي روبن عن السفير الأمريكي ريان سي كروكر تقييمات مثيرة، قال فيها عن سوريا: « أنفقنا عقودا من الزمن نكتب المذكرات لصناع القرار حول الإصلاح في سوريا، وكما تعلمون لم يكن هناك وجود لإصلاحات .. والآن، لستُ متأكدا من أننا نستطيع عمل الكثير للسيطرة على الوضع».
ومع ذلك فقد يضطر « المركز» إلى التدخل بصيغة « مكرها أخاك لا بطل». فبما أن سوريا تمثل إحدى أقوى مرابط النظام الدولي في أشد المناطق حساسية وخطورة في العالم فإن التدخل يصبح أرجح. إذ أن الخيارات الماثلة أمام « المركز» تؤكد أنه أمام خيارين لا ثالث لهما: (1) إما التسليم بالفوضى العارمة وبخطر انهيار النظام الدولي و (2) إما التدخل.
لذا فإن عين الحقيقة تؤكد: أن « قضية التدخل العسكري قضية حية. وربما يكون القادة السياسيون الغربيون ليست لديهم الرغبة للتدخل الأعمق، لكن وكما يعلمنا التاريخ، فنحن لا نختار دائما الحروب التي نخوضها، أحيانا الحروب هي التي تختارنا … يتحمل المخططون العسكريون مسؤولية إعداد خيارات التدخل في سوريا لقادتهم السياسيين في حال اختارهم هذا الصراع. والإعداد سيتم اليوم في عدة عواصم غربية وفي الميدان بسوريا وفي تركيا» !!! هذا التصريحات نقلتها صحيفة « الديلي تلغراف – 27/7/2012» البريطانية عن ريتشارد كيمب، العقيد والقائد السابق في أفغانستان، وجاءت في سياق ورقة أعدتها مجموعة للبحث في شؤون الدفاع بعنوان: « سوريا: توجه للتدخل»، وقُدمت إلى المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة « رويال يونايتد سيرفيسس إنستتيوت».
وبحسب الورقة فإن: « 75 ألف جندي هو العدد المطلوب لتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية السورية والتخلص منها بسلام» .. لكن بحسب مايكل كودنر، مدير قسم العلوم العسكرية بالمعهد، يقول أن: « نقطة البدء لحساب التدخل الكامل ستكون 300 ألف جندي على الأقل». أما لماذا هذا الجيش العرمرم؟ فلأن مجموعة البحث ترى في النهاية أن الثورة السورية: « بدلا من أن تنفجر انفجارا داخليا مثل الدول العربية الأخرى التي شهدت ثورات، فإن سوريا سوف تنفجر إلى الخارج لتتقيأ مشاكلها على نطاق الشرق الأوسط بأكمله، مع احتمال حدوث تداعيات كارثية» .. هذه « عين الحقيقة»!!!
أما قبل سقوط الأسد، فإن عين الحقيقة من وجهة النظر الأمريكية ترى، بحسب صحيفة « لوس أنجلوس تايمز – 23/8/2012» الأمريكية، أن: « البنتاجون أعد خططا طارئة لإرسال قوات متخصصة إلى سورية إذا ما قرر البيت الأبيض تأمين مستودعات الأسلحة الكيميائية .. وأن تأمين مواقع تلك الأسلحة قد يقتضي غارات تشنها خلسة فرق القوات الخاصة المدربة على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة». لكن في هذا السياق يجري الحديث الأمريكي المرتبك عن فرض حظر جوي جزئي أو إقامة ممرات آمنة تسمح بالتحرك، وهو ما اعترفت به وزيرة الخارجية (12/8/2012) ووافقها فيه كبير مستشاري الأمن القومي الأميركي جون برينان حين قال: « إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة» في حين استبعده وزير الدفاع ليون بانيتا (15/8/2012).
لكن بعد السقوط، وبحسب صحيفة « كريستيانس ساينس مونيتور – 27/7/2012» فإن: « الولايات المتحدة ربما يتوجب عليها أن تتسلم زمام المبادرة لمنع الفوضى في قلب الشرق الأوسط بتأمين الأسلحة النووية ومنع أي تدخل من إيران في سوريا»، وتنقل الصحيفة عن الأدميرال وليام ماكرافن، رئيس قوات العمليات الخاصة، شهادة سابقة قال فيها أن: « تأمين الأسلحة الكيميائية يحتاج لجهد دولي لدى سقوط الأسد».
ومن جهتها تنقل وكالة الأنباء البريطانية « رويترز – 17/8/2012» عن مصادر دبلوماسية أميركية، ناقشوا سرا أسوأ السيناريوهات المحتملة في سوريا، أنهم توصلوا إلى خلاصة ترى: « إن تأمين مواقع الأسلحة الكيميائية قد يتطلب ما بين خمسين وستين ألف جندي». لكن مصدران آخران شاركا في النقاش قالا للوكالة: « حتى في حال نشر قوة من ستين ألف جندي فلن تكون كافية لحفظ السلام بل لحماية مواقع الأسلحة فقط، وستبدو مثل قوة احتلال أجنبية على غرار ما حدث في العراق .. وأنه لم يتضح بعد كيف سيجري تنظيم هذه القوة العسكرية وما هي الدول التي قد تشارك فيها؟».
عين الحقيقة أن « المركز» يفتش عن أقل التدخلات تكلفة. فهو يخشى من تدخل قبل سقوط الأسد وبعده. ولأن (1) استراتيجيات « المركز» تقوم على احتلال الجيوش وأجهزة الأمن وتوظيفها في خدمة مصالحه وأهدافه؛ ولأن (2) « المركز» لا يمتلك بديلا عن النظام إلا النظام، وفق صيغة « الحل مع النظام»، فمن الأولى والأجدى له أن يحتفظ بكل الإرث الأمني والعسكري للنظام كي يستخدمه في السيطرة على الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد وليس النظام. وإنْ لم يفعل ذلك فسيخسر.
إذن عين الحقيقة أن « المركز» صار لديه خياران: (1) إما الاحتلال وإخضاع سوريا لـ « وصاية عسكرية وأمنية» مباشرة و (2) إما إخضاعها محليا عبر تمرير صيغة « الحل مع النظام». أما أهدافه فهي: (1) منع خروج الثورة السورية من حدودها، و (2) تأمين الأسلحة الكيميائية، و (3) الحيلولة دون تحول سوريا إلى فضاء مفتوح لتيارات « الجهاد العالمي».
وبحسب الخيارين تبدو الولايات المتحدة نادمة على ما فعلته في العراق حين فككت الجيش وأجهزة الدولة!! وتبعا لذلك فهي عازمة على تجاوز ما تراه « أخطاء حرب العراق» التي لا تريد أن تكررها في سوريا. وعليه فهي تسعى إلى تمرير « صيغة الحل مع النظام» على ظهر « عسكريين منشقين» و « قوى سياسية» وأخرى « مدنية» يوفرون لها الغطاء الشرعي المطلوب، عبر يافطة شعبية يمكن خلقها إن لم تكن موجودة. هذا ملخص ما قاله وزير الدفاع ليون بانيتا في مقابلة تلفزيونية في 31/7/2012: « إن الحفاظ على الاستقرار في سوريا سيكون مهما وفق أي خطة تتضمن رحيل الأسد عن السلطة، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو الحفاظ على أكبر قدر من الجيش والشرطة متماسكاً». وهو عين ما تناقلته وسائل الإعلام عن كلينتون 12/8/2012: « يتوجب على الشعب السوري قيادة عملية الانتقال السياسي وأن يحافظ على سلامة المؤسسات السياسية بالبلاد». وليس هذا ، بطبيعة الحال، بعيدا عن موقف المبعوث الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي وهو يعبر عما قاله بانيتا وكلينتون بالصيغة الدبلوماسية: « على السوريين أن يجتمعوا معا على كلمة واحدة من أجل التوصل إلى صيغة جديدة. هذا هو السبيل الوحيد ليتمكن جميع السوريين من العيش معا في سلام في مجتمع لا يقوم على الخوف من الانتقام بل على التسامح».
عين الحقيقة أنهم يسارعون الخطى لاحتواء الثورة السورية خشية « أسلمة الصراع في سوريا» كما تقول صحيفة « لوفيغارو – 12/8/2012» الفرنسية، فـ: « كلما طال أمد الصراع .. كلما انجذب إليه المزيد من الجهاديين الذين لا تعنيهم مسألة بناء سوريا جديدة»!!! وكأن « الجهاديين» هم الذين دمروا سوريا!!! هذا من جهة. أما من الجهة المقابلة فبسب الخشية على وجود « إسرائيل». فلنتابع مع يقوله المسؤولون اليهود:
ففي أعقاب « عملية سيناء – 6/8/2012» التي قتل فيها 16 جنديا وضابطا مصريا؛ ثار جدل بين الخبراء اليهود حول أمن « إسرائيل» ومستقبلها في ضوء الثورة السورية. ونقلت صحيفة « ديلي تلغراف – 10/8/2012» عن تحليل بموقع « ذي ديلي بيست الأميركي» تصريحا لديفد بوكاي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة حيفا بإسرائيل، قوله: « أعتقد أننا بدأنا نستيقظ ونفهم أخيرا أن عدم الاستقرار، في سوريا أكثر منه في مصر، يسمح للجماعات الجهادية بأن تأخذ مكانها. وعلى الشعب أن يفهم أن البديل عن بشار الأسد هو القاعدة». أما أفيف كوتشافي، لواء بالجيش، فقال بأن: « منطقة الجولان عرضة لأن تصير ساحة عمليات ضد إسرائيل بنفس الطريقة التي تحدث في سيناء الآن, وأن هذا نتيجة التحصن المتزايد للجهاد العالمي في سوريا».
وفي سياق الجدل الدائر في « إسرائيل» حول جدوى مهاجمة إيران قد يبدو ملفتا للنظر أن يعين، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في 12/8/2012 زميله الجنرال المخضرم آفي ديختر وزيرا لـ « الجبهة الداخلية» لأول مرة في تاريخ « إسرائيل». لكن المدهش ليس في التعيين بل فيما جاء بكلمة ألقاها ديختر في 19/8/2012 في « قاعدة رابين» بمدينة « تل أبيب»، بمناسبة تعيينه: « إن الربيع العربي أحدث زلزالا في المنطقة, ويتعين تبعا لذلك على القيادة الإسرائيلية أن تراجع سياستها, معتبرا أن وجود إسرائيل بات مهددا بشكل جدي». أما الأشد دهشة وخطورة فيكمن فيما أضافه بالقول: إن القدرات الدفاعية والهجومية الضخمة للجيش الإسرائيلي تهدف لضمان عدم تحول الجبهة الداخلية إلى خط الجبهة».
أخيرا
لم يبق من عين الحقيقة إلا التذكير بـ (1) أن صيغة « الحل مع النظام» يعني طي ملفات عقود الدم من القهر والذل والمذابح والعنصرية والخوف والإرهاب والتشريد … ومكافأة المجرمين والقتلة، مثلما يعني بقاء سجل الإجرام مفتوحا على مصراعيه، بل ومشفوعا بامتيازات للطائفة لن تتغير أبدا. وفي مثل هذه الحالة سينطبق على الثورة السورية القول المأثور: « كأنك يا أبو زيد ما غزيت». فما الذي يخيف السوريين من حسم خياراتهم إذا كانت النتيجة كارثية؟
و(2) أنه إذا كان إخضاع سوريا لـ « وصاية عسكرية» أجنبية مباشرة تستهدف إحكام السيطرة على الحدود، والحيلولة دون تدفق عشرات أو مئات الآلاف من المسلمين على البلاد، بما ينذر بانفجار المنطقة، إلا أنه سيظل خيارا خطرا على « المركز»، كونه سيوفر تمايزا عقديا، تنكشف بموجبه كافة القوى والجماعات والأفراد والشخصيات، ويصب في النهاية في صالح الجهاديين الذين سيشعرون بتوفر فرصة ذهبية لمنازلة « المركز» في ساحة بالغة الحساسية وقابلة عقديا للاستقطاب الإسلامي من شتى أنحاء العالم، باعتبار أن « الوصاية العسكرية» غير مقبولة عقديا، فضلا عن أنها لا يمكن لمخرجاتها أن تصب في صالح الثورة السورية أو المسلمين. ومن الطريف أن الذين يؤيدون تدخل « المركز» في إسقاط الأسد أو ضبط الأوضاع لا يفكرون بأية مسؤولية عقدية أو تداعيات لما قد يتمخض عنه التدخل الدولي.
أما (3) لجوء الطائفة إلى بناء جيب علوي على امتداد الساحل، وهو ما حذر منه الملك الأردني، فهو حقيقة واقعة، وخيار يمكن أن يمثل الملاذ الأخير للنظام. لكن مثل هذه الخيار سيعني الشروع في تقسيم سوريا وتشجيع الطوائف الأخرى كالأكراد وغيرهم على تحصين أنفسهم بجيوب مماثلة. ومع أنه خيار وارد إلا أنه تداعياته كبيرة للغاية، كونه سيؤدي إلى انفلات النظام الدولي ووقوعه في حروب إقليمية وطائفية وعقدية لن تكون « إسرائيل» نفسها بمنآى عن شررها.
في المحصلة فإن كل ما يجري حتى الآن من تحركات سياسية أو عسكرية أو أمنية في المسارات الدولية تقع في نطاق السيناريوهات وليس في نطاق الحسم. ربما تكون مسألة الأسلحة الكيميائية هي الوحيدة التي حظيت بالحسم لدى « المركز». لكن لا أحد لديه القدرة حتى اللحظة على تقديم تصور حاسم فيما يتعلق بمصير الثورة السورية أو الطائفة أو النظام أو النظام الدولي. وهذا يعني أن الثورة السورية هي الثابت الوحيد في الحدث في حين يظل ما حولها عواصف عاجزة حتى اللحظة عن إحداث أي فارق ميداني .. لكن إلى متى والمخاطر تحدق في الثورة من كل جانب؟
http://www.almoraqeb.net/main/articles-action-show-id-382.htm
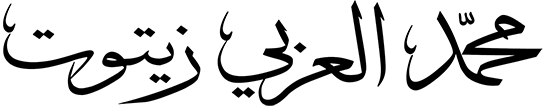


التعليقات مغلقة.