الثورة والثورة المضادة في مصر العروبة – قاسم عز الدين
متشابهات كثيرة بين ثورتي تونس ومصر ومفارقات كبيرة. ومن أصعب هذه المفارقات أن الثورة المضادة في تونس بدأت بعد أن وصلت الثورة إلى قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام قبيل رحيل بن علي بأيام أربعة، بينما بدأت الثورة المضادة في مصر باكراً قبل أن تستكمل الثورة خطواتها الأولى.
ففي تونس أطلق بن علي صافرة الثورة المضادة في خطاب “لقد فهمتكم” فأفلت مليشيات الحرس الجمهوري وعصابات الشرطة السرّية تروّع الناس في بيوتهم وأحيائهم تأييداً “لدعم الإصلاحات”. وفي مصر كذلك أطلق حسني مبارك صافرة الثورة المضادة في خطاب “أموت على أرضها” وأفلت مليشيات الحزب الحاكم وعصابات “البلطجية” تروّع الناس تأييداً “لدعم الإصلاحات”.
” في تونس ومصر سعت السلطة إلى إشاعة رعب الثورة المضادة على طريقة فوضى ديكتاتوريات أميركا اللاتينية, وفي الحالتين ردّت الثورة بتنظيم اللجان الشعبية لحماية الأحياء والأرواح والممتلكات العامة ”
وفي الحالتين سعت السلطة إلى إشاعة رعب الثورة المضادة على طريقة فوضى دكتاتوريات أميركا اللاتينية. وفي الحالتين ردّت الثورة بتنظيم اللجان الشعبية لحماية الأحياء والأرواح والممتلكات العامة. لكن ثورة تونس كانت قد تقدمت في ملاحقة فلول الثورة المضادة وفي تصعيد حراكها لإسقاط السلطة بينما لم تكن ثورة مصر قد تقدّمت بعد.
فالثورتان تتشابهان في اعتمادهما على الزخم الجماهيري السلمي لإسقاط النظام، إنما تتفارقان في ثقل كل من بلديهما السياسي والإستراتيجي، وفي تجربة قيادتيهما الشبابية، وفي ثقل وامتداد قوى الثورة المضادة في البلدين. وقد يكون من الخطأ المبالغة في مقارنة متشابهات الثورتين وترقّب إنجازات سريعة حاسمة في مصر على غرار ثورة تونس كقصّة من حكايات ألف ليلة وليلة.
رغبنا أن نتصوّر في مصر سيناريو ثورة تونس أو ما قيل عنها على وجه السرعة والتسرّع أحياناً. فالمناخ السياسي والشعبي العام بعد رحيل بن علي، حمل على الاعتقاد أن مظاهرة حاشدة في أي بلد عربي تهتف بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” يؤول مآلها إلى هروب الحاكم وسقوط النظام.
لكن هذا الشعار كان في تونس تعبيراً عن تحديد شعار الخطوة الآنية بعد تراجع الرئيس ومحاولة إجهاض الثورة. ففي إثر مجزرة “القصرين” في الأسبوع الأول من ثورة تونس تحررت مناطق الجنوب من حكم قيادات الحزب الحاكم في الولايات والمحافظات ومن قيادات أجهزة القمع.
وفي هذا أسقطت الثورة عملياً النظام في المناطق المحررة وانطلقت منها لملاحقة النظام وإسقاط سيطرته على الدولة في العاصمة بينما ظلّ النظام يتهم عناصر ذات “أجندات خارجية في زعزعة الأمن”. فالثورة بدأت من الريف الأكثر جفافاً وفقراً، لكنه الأكثر تجربة في تاريخ الانتفاضات والأكثر خبرة في قمع السلطة وإجهاض الانتفاضات.
وقد بدأتها من المدخل الاجتماعي السياسي الذي يتضمّن كل مضامين الثورة الكاملة على الاستبداد السياسي وإلغاء الحريات، وعلى الفساد ونهب الثروة العامة، وعلى تبعية النظام إلى أوروبا وأميركا. وقد لعبت قواعد الإتحاد العام للشغل التي تتمتع بخبرة عمالية عريقة، دوراً حاسماً في التنسيق بين جهوية وأخرى وفي احتضان الفعاليات الجهوية السياسية والشعبية والحقوقية وفي تصعيد حراك الثورة وامتدادها.
وبخلاف ثورة تونس انطلقت ثورة مصر من مدخل الحقوق المدنية والحريات السياسية لإسقاط النظام ممَثّلاً بشخص رئيسه، وعلى اعتبار أن الحزب الحاكم لا يحكم الدولة بل هو حزب الحاكم (الرئيس) الذي يحكم الدولة.
وهي ثورة تتضمن أبعاداً وطنية ظاهرة ضد التبعية إلى أميركا وإسرائيل، وأبعاداً اجتماعية وثقافية واقتصادية، لكن الحريات السياسية والحقوق المدنية هي بطبيعتها مطالب إصلاحية في النظام لا إسقاطه.
وستبقى إصلاحية سواء رحل الرئيس أم لم يرحل، ما بقي حزب الرئيس يحكم الدولة وما بقي دستور الحزب الحاكم قائماً حتى لو جرى تعديل المواد 76 و77 و88 كما تشتهي المعارضة الطامعة بمشاركة حزب الرئيس في البرلمان. والمنظمات المدنية التي قادت الثورة هي منظمات حقوقية مدنيّة ومدينيّة أبرزها حركة كفاية وحركة 6 أبريل ومركز هشام مبارك ومركز الدراسات الاشتراكية. وقد خاضت كلها معاركها السابقة من أجل مطالب إصلاحية مثل حرية الانتخابات ورفض التوريث وحالة الطوارئ، أو نشطت في إقامة دعاوى قانونية أو الدفاع عن حرية التعبير وحقوق المساجين وغيرها.
والزخم الجماهيري الواسع الذي شعرت بوجوده أثناء التحضير إلى التظاهر لم يكن تجاوباً مع مطالبها الإصلاحية، بل كان من آثار نجاح ثورة تونس في إسقاط النظام بسهولة نسبية غير متوقعة. لكن ثورة تونس أخذت النظام ومعه كل الأجهزة والإدارات الداخلية والخارجية على حين غرّة. كما أنها لم تترك له فرصة استعادة أنفاسه في زمام المبادرة بل لاحقت مجموعات من الشباب المطرودين من سوق العمل الأوروبية، زمرة أقرباء بن علي وزوجته في عمليات أشبه بانتفاضة الحجارة في فلسطين وبانتفاضة الضواحي الباريسية.
وفي هذا التصعيد والامتداد كالنار في الهشيم، عطّلت الثورة إمكانية تدخّل الجيش لحماية النظام أو جعلت هذه المهمة شبه مستحيلة أمام عدسات وسائل الإعلام وناشطي “فيسبوك”. والحال في مصر على غير حال.
فالنظام الحاكم كان مستعداً ذهنياً على الأقل لاحتمال اندلاع “اضطرابات” ما. كما أن الأجهزة والإدارات الأميركية والأوروبية كانت تستعد بدورها وما زالت تطبخ في رأسها سيناريوهات مختلفة لأشكال تدخّلها في مصر وغير مصر من أجل تغيير الوجوه حفاظاً على النظام.
” تختلف مصر عن تونس في سعة مساحتها الجغرافية وفي ثقلها الجيوإستراتيجي وفي تراكم الخراب الداخلي والإقليمي الذي عمل له النظام بشكل ممنهج منذ اتفاقيات كامب ديفد والانفتاح الاقتصادي ”
وحال مصر على غير حال في سعة مساحتها الجغرافية وفي ثقلها الجيوإستراتيجي وفي تراكم الخراب الداخلي والإقليمي الذي عمل له النظام بشكل ممنهج منذ اتفاقيات كامب ديفد و”الانفتاح الاقتصادي”. وحالها على غير حال في حجم وثقل قوى الثورة المضادة وسعة امتداداتها في الداخل والخارج وكلها يرتهن بقاؤها في بقاء النظام.
وفي مقدمة هذه القوى مليشيات أمن الدولة والمخابرات العامة التي يتجاوز عددها مليونا ونصف المليون عدا “بلطجية” أحياء البؤس الذين يسهّلون قمع النظام مقابل تسهيل التهريب والسوق السوداء و”الفتوّة” بين تسعة ملايين في “الأحياء العشوائية” في القاهرة وحدها.
وإلى جانب الأمن تقف قيادات المؤسسة العسكرية التي غيّر النظام إستراتيجيتها القتالية وصفّى خيرة ضباطها وأشرك الباقي في صفقات القطاع الاقتصادي الذي تديره المؤسسة أو في تعيين بعضهم في المحافظات والإشراف على تصفية شركات القطاع العام.
وإلى جانب الاثنين يتجنّد الحزب الحاكم الذي يتسلّط على إدارات الدولة وعلى موظفيها ويستخدم إمكانياتها الطائلة في توظيف زبائنية واسعة من البيروقراطية الفاسدة ومنافقي الإعلام ومؤسسات سوزان مبارك “الفكرية” فضلاً عن مرتزقة الثقافة والفن والسينما.
وفوق كل ذلك شريحة واسعة من رجال الأعمال الذين تتربع على رأسهم ثلاثون عائلة نافذة تنتسب إلى نادي أغنى أغنياء العالم. وهذه العائلات لها نفوذ لا يستهان فيه على الأطيان والفلاحين بعد إعادة الباشوية إلى مصر إثر القضاء على الإصلاح الزراعي. وعلى عمال شركات “القطاع الخاص” المسروق من القطاع العام. لكن نفوذها الأكبر هو في شراكتها مع “الاستثمار الأجنبي” في المشاريع الإستراتيجية كالنفط والغاز والمياه والكهرباء وغيرها التي تتصل ببعضها البعض من أعالي النيل إلى القوقاز.
وهي مشاريع تموّلها الشركات متعدية الجنسية و”الدول المانحة” وتديرها المؤسسات الدولية ومكاتب “الخبرة” (منها مبعوث وزارة الخارجية الأميركية فرانك ويسنر) المرتبطة بأجهزة أميركا وأوروبا وإسرائيل.
وليست هذه المشاريع إستراتيجية بمعنى حجم الاستثمار الرأسمالي بل بمعنى تبعيتها إلى إستراتيجية “المجتمع الدولي” في حماية أمن إسرائيل في سياسة “السلام” وفي مكافحة “الإرهاب”، وفي إغراق مصر بالديون ونهب الثروات الطبيعية، وفي تجنيد السلطة وزبائنة النظام للدفاع عن هذه الإستراتيجية مقابل المشاركة في النهب.
فكل هذه القوى تعمل جاهدة للمحافظة على استقرار مصالحها الخاصة في استقرار النظام متمثّلاً في بقاء تسلَطها وتسلّط الحزب الحاكم على الدولة. وإلى جانبها تعمل إدارات أميركا وإسرائيل وأوروبا، خوف أن تتجذّر الثورة، على تجديد النظام في إجراء إصلاحات دستورية وتغيير الوجوه، حتى إذا استدعى الأمر في لحظات حرجة رحيل مبارك.
وتخوّف أميركا وأوروبا من تجذّر الثورة في محلّه تماماً. فمنذ “واقعة الجمل” كما أطلق عليها شباب ميدان التحرير، تتجذر الثورة يوماً بعد يوم. فقد تعرّف شباب الثورة على بعضهم البعض في الميدان. وانتزعوا شرعية التمثيل على الرغم من التفاف النظام وانتهازية الأحزاب السياسية ولجان “الحكماء”. وأثبتوا هراء إدعاءات التيارات السياسية والفكرية حول جهل الناس بل أثبتوا عقم هذه التيارات ومدى تعلّقها في مصالحها الضيّقة الخاصة.
وفي الميدان عطّلت الثورة إمكانية بطش “بلطجية” الثورة المضادة في وضح النهار. وعطّلت كذلك إمكانية تحرّك دبابات المؤسسة العسكرية لدعم النظام جهاراً. وعطّلت أيضاً التفاف الأحزاب السياسية ولجان “الحكماء” على الثورة وتركتهم يتحاورون مع النظام حول جنس الملائكة في فقه الدستور.
” خرج مارد الثورة من القمقم ولن يعود إليه, ومن الخطأ المبالغة في انتظار نتيجة سريعة حاسمة على غرار ثورة تونس, وإن كان النظام في مصر تضيق عليه خيارات “البلطجة” لإطفاء جذوة الثورة ”
وفي مقابل هذا النجاح في المحافظة على استمرار الثورة، تطعّمت ثورة الحقوق المدنيّة في الميدان بطعم الحقوق الوطنية ضد تبعية النظام إلى أميركا وإسرائيل. وبطعم الحقوق الاجتماعية والثقافية والحريات السياسية والديمقراطية. فلم يعد ميدان التحرير يقتصر على الشباب الثوريين الذين يراكمون كل يوم معرفة في التنظيم والإدارة والتدبّر، بل بات يضم الفئات العمالية والفلاحية إلى جانب أحرار المثقفين والجامعات والإعلاميين والفنانين والحقوقيين ورجال الدين. وباتوا كلّهم يتنفسون في الميدان هواء الحرية النظيف ويتذوّقون نعمة التضامن في الأفراح والأتراح. ويتعلّمون من خبرات بعضهم البعض خبرة مشتركة لم يعهدوها من قبل في تحمّل المسؤولية. وقد بدأت كل جماعة مهنية تعدّ تحرّكها في تصعيد الثورة وتكاملها بين مجمل فئات الشعب.
لقد خرج مارد الثورة من القمقم ولن يعود إليه. ومن الخطأ المبالغة في انتظار نتيجة سريعة حاسمة على غرار ثورة تونس. فالنظام في مصر يضيق عليه الوقت وتضيق عليه خيارات “البلطجة” لإطفاء جذوة الثورة. وما زال أمام الثورة مساحات نضالية كثيرة وخيارات متعددة. وما زال أمامها متسّع من حرية الحركة وتصعيد الثورة في الأرياف بين الفلاحين ضد متسلطي النظام على الأرض والمياه والزرع والضرع. وفي تطهير النقابات والروابط المهنية وإدارة الجامعات من “بلطجية” الحزب الحاكم. وفي تطوير تجربة اللجان الشعبية والإدارة الذاتية في الأحياء والمصانع.
المهم أنها أحرقت مراكب العودة إلى الوراء وتسد الطرق شيئاً فشيئاً أمام الثورة المضادة. والأهم أن “أم الدنيا” تستعيد عافيتها ولن تعود إلى الوراء في عصر الثورات الشعبية العربية وعصر انحدار إستراتيجيات وسياسات “المجتمع الدولي”.
المصدر الجزيرة
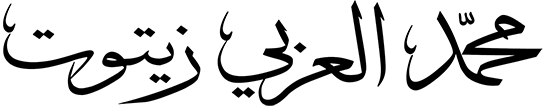


التعليقات مغلقة.