هل تتشابه الثورات العربية؟
لم يحرق الشاب “محمد بوعزيزي” نفسه في ولاية سيدي بوزيد التونسية احتجاجاً على أوضاعه الاقتصادية فحسب، بل ولسببٍ رئيسٍ أيضاً هو إهانة إحدى الشرطيات لكرامته الإنسانية بصفعه على وجهه لأنه تجرأ على المطالبة بحقوقه الإنسانية. أطلق البوعزيزي صرخته الغاضبة، لتدوّي في العالم العربي، وتعجّ الشوارع العربية بالمتظاهرين السّاعين لنيْل حقوقهم ومطالبهم.
لم تمهل مصر حاكمها أكثر من 18 يوماً ليغادر الحكم. وحاكى شباب اليمن مباشرةً تجربة ميدان التحرير، وأذهلوا العالم بمدى تحضّرهم وسلميّة ثورتهم. وفي ليبيا، انطلق الثوّار، في 17 فبراير/ شباط ،لإقامة نظام بديلٍ عن اعتباطية نظام القذافي.
أمّا في سوريا، فقد انطلقت الاحتجاجات من مدينة درعا التي تعاني أيضاً من التّهميش، وتعتبر من أكثر المناطق المصدّرة للعمالة من سوريا إلى الخارج. وكما في سيدي بوزيد انطلقت الاحتجاجات رداً على اعتقال شباب وأطفال في سنّ التعليم الأساسي (ما دون 15 سنةً)، وعدم تجاوب بعض الجهات المعنيّة مع الأهالي في الإفراج عنهم.
يسمح ذلك بالقول إنّ العامل الحقيقي الذي يقف وراء هذه الثورات المندلعة في أكثر من بلد عربي، هو أنّ المجتمعات العربية قد أصبحت أكثر تطوّراً من أنظمتها السياسيّة التي أصبحت بنيتها قاصرةً عن تحقيق مطالب شعوبها، بل وتحوّلت إلى عائق أمام تطوّر بنية الدول العربية الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
ويتمثّل هذا العائق في التّهميش الاقتصادي والسياسي للفئات العامّة من الشعب، ولاسيّما الشباب منها، والذي يخلق بطبيعته بيئةً خصبةً قابلةً للاحتجاجات وفي ظلّ غياب المؤسّسات والقنوات السياسيّة الفعّالة التي تمكّن الناس من طرح مطالبهم يلجأ المتظاهرون إلى الشارع وسيلةً لإيصال مطالبهم. والسّؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الأسباب التي قادت إلى هذا التّهميش الاقتصادي والسّياسي؟ وهل تشابه الأسباب التي حكمت اندلاع الثورات يعني تشابهها من حيث النتائج؟
اتّبعت حكومات الدول العربية برنامجاً اقتصادياً يستند إلى وصفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي لصندوق النقد الدولي، ولكن الخصخصة المباشرة أو غير المباشرة أفرزت طبقة من رجال الأعمال الجدد احتكرت ثمار النموّ الاقتصادي. وقد احتكرت ثلّة ضيّقة من رجال الأعمال المشاريع وثمار النموّ معاً، تردّدت أسماء شهيرة في مصر كأحمد عزّ وحسين سالم وآخرين باحتكارها لقطاعاتٍ واسعةٍ من الاقتصاد المصري، أمّا في سوريا فقد احتكر مئة من رجال الأعمال الجزء الأكبر من النّشاط الاقتصادي السّوري.
أنتج هذا النهج النيو الليبرالي التسلّطي تحكّم فئة قليلة جداً من رجال الأعمال في اقتصادات الدّول العربية، على الرغم من أنّ تجارب الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيّة قد أثبتت عدم نجاح ذلك النهج في تحقيق التّنمية الشاملة، حيث قد ينجح في تحقيق نموّ اقتصادي، ولكنه يخفق في توزيع الثروة، ممّا يخلق طبقة تزداد ثراءً، وطبقة تزداد فقراً، وهو ما حدث في الدول العربيّة التي اتّبعت تلك السياسات. ممّا أدّى إلى تقلّص تكديح الطّبقة الوسطى التي ظلّ عددها ينخفض تدريجياً.
ساهمت الطّبقة الوسطى في تحرير الدّول العربيّة من الاستعمار، وعاشت فترتها الذهبيّة في مرحلة ما بعد الاستعمار بسبب انتشار التعليم بين أوساطها وبالتالي حصولها على الوظائف الحكوميّة التي كانت تمثّل قيمةً اجتماعية مهمّة في ذلك الوقت. وبما أنّ الطّبقة الوسطى هي التي تقود عادةً التغيير الاجتماعي ومن ثمّ الاقتصادي والسياسي، حدث هناك نوعٌ متقدّم إلى حدٍّ ما من الحراك السّياسي في مناخ من الانفتاح والحرية. لكن الدول العربية ما لبثت أن وقعت تحت حكم أنظمة ديكتاتوريّة فاسدة قضت على تجربة الانفتاح السّياسي السابقة ونتيجة لذلك بدأت الأنظمة العربية ذاتها تتحجّج بأنّ مجتمعاتها غير كفؤة لتقبّل العمليّة الديمقراطية، ، لذلك فإنّ من أبرز نتائج الثورات العربية أنها أسقطت تلك المقولة السلطوية، كما أعادت الاعتبار للطبقة الوسطى، ولدورها في المجتمع.
يقابل هذا الانحدار الاقتصادي، تهميشٌ سياسي إلى أبعد الحدود يتمثّل في عدم تمكين المواطنين من المطالبة بحاجاتهم الاقتصاديّة وحقوقهم السياسيّة، في ظلّ سيطرة حزبٍ واحد على السّلطة بشكل الحزب المسيطر أو الجبهوي من أنماط “حزب الواحد والنصف” أو ما يشبه ذلك، وتدنّي الكفاءة الداخليّة والخارجية لمؤسّسات الدولة، وتحوّلها إلى أدوات بيد البيروقراطيات السياسية، وتحوّل السلطة التشريعية إلى ملحق بالسلطة التنفيذية، ومن يقبع خلفها من تحالف البيروقراطيات السياسية مع رجال الأعمال إضافةً إلى تفشِّي الفساد في السلطة القضائية، وهشاشة استقلالها.
ولعلّ أبرز الأمثلة على غياب عمل المؤسّسات بشكل كامل في الوطن العربي هو تعطيل عمل البرلمانات عن القيام بدورها الأساسي. ومن الأمثلة الجوهريّة على ذلك عدم اعتراض مجلس الشّعب المصري على مجالات إهدار فرص مصر في التّنمية من خلال تسخير الموارد الطبيعيّة المصرية لصالح بعض الجماعات المعيّنة بدلاً من أن تكرّس لدعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدّخل. خاصّةً فيما يتعلّق ببيع الغاز الطبيعي، وتصديره إلى إسرائيل، وبأسعار لا نظيرَ لها في العالم، ولا يوجد تفسير لذلك إلاّ عمل تلك الطبقة المستفيدة على ضمان مشروع التّوريث.
لم يُثِرْ مجلس الشعب في سوريا أيضاً قضيّة دفن عبد الحليم خدام للنفايات السامّة في سوريا إلاّ عند خيانته لسوريا والشعب السوري والتي تركت أثراً سلبياً عميقاً لدى المواطن السوري في مدى استهتار ممثّليه بالأمن الوطني السوري وسكوتهم عنه كلّ هذه المدّة. إضافةً إلى أنّ مسألة رفع الدّعم عن المحروقات لم تَلْق اعتراضاً في مجلس الشّعب رغم ما تركه ذلك من آثارٍ سلبيّة على الزّراعة والطبقات الفقيرة العاملة، مع أنّ نصف أعضاء المجلس على الأقلّ يجب أن يكونوا من العمّال والفلاّحين وفقاً للدستور السوري.
من خلال ما سبق، يتّضح أنّ المطلوب حالياً من أجل إعادة بناء الدول العربية في مرحلة ما بعد الثورات، هو اتّباع نموذج تنموي بديل ينهي احتكار القلّة ممثّلاً بظاهرة سيطرة رجال الأعمال على حياة الدولة الاقتصاديّة ، وإعادة الاعتبار للدّور التنموي للدولة في القطاعات الإنتاجية التي يحْجم القطاع الخاصّ عن الاستثمار فيها. وذلك لكي ينعكس النموّ الاقتصادي على كافّة أفراد المجتمع وليس على فئة معيّنة بما يحقّق العدالة الاجتماعيّة في توزيع الدّخل الوطني، إضافةً إلى دعم دور الدولة في مختلف المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية، وخاصّةً في القطاعات الاستراتيجيّة التي تمثّل ركائز الاقتصاد الوطني وعندها نستطيع أن نتحدّث عن تنمية قادرة على تلبية مطالب الشّعب الاقتصاديّة. أمّا التنمية السياسية فلا يمكن أن تتحقّق إلاّ بالانتقال إلى نظام ديمقراطي يقوم أساساً على فتْح دائرة المشاركة السياسيّة عن طريق حريّة تشكيل الأحزاب السياسيّة وفعاليّة منظّمات المجتمع المدني، واعتماد مبدأ التّداول السلمي للسّلطة وفق آليّات دستوريّة فعّالة. ويتمّ ذلك بتزامن التّنمية الاقتصاديّة والسياسيّة مع بعضهما البعض أو بأسبقيّة التنمية السياسيّة على الاقتصادية حتّى يبقى هناك مراقبة ومحاسبة لآليّات عمل الحكومات عن طريق البرلمان وصندوق الاقتراع.
رغم أنّ الدول العربيّة تشترك في تشابه طبيعة أنظمتها الحاكمة ، لكنها تختلف من حيث البنية الاجتماعية في تركيبتها، لذلك ، فليس كلّ ما يصحّ في مصر والمغرب العربي قد يصحّ في المشرق العربي.
لقد أفرز الموروث الاجتماعي التاريخي المستمدّ من دور الاستعمار، والقمع والاستبداد السياسي والاجتماعي الذي مارسته الأنظمة السياسية العربية لاحقاً، هويّاتٍ وانتماءاتٍ فرعيّة في المجتمعات العربية وخاصّةً المشرقيّة منها، تكون أكثر وضوحاً في ظلّ عدم الاستقرار السّياسي الداخلي، نتيجة الشّعور بعدم الأمان. ومن البديهي أنّ المجتمعات التي تعاني من أزمة في الهويّة هي عاجزة عن تحقيق تكامل وطني بين مكوّناتها الشّعبيّة، نتيجة تضارب الهويّات الفرعية، في ظلّ غيابٍ كامل للدّيمقراطيّة. ممّا يسمح لبعض الزّعامات غير المدنيّة بالتأثير في الشّعب بشكل سلبي يعبّر عن هواجسها الطائفيّة أو العشائريّة. إنّ ظروف الغموض قد تساعد في تنامي الشّعور بالهويّات الفرعيّة على حساب الهويّة الوطنية، خصوصاً في ظلّ غياب المؤسّسات المدنيّة القادرة على تأطير المواطنين سياسياًّ واجتماعياًّ و تحميهم من تأثير تلك الزعامات غير المدنيّة.
ولا يخرج عن هذا الإطار دورُ النّظام السّياسي في إشاعة أساليب التّخويف وتحريض البعض ضدّ الآخر من خلال بعض الأعمال. وليس بالضّرورة أن تقوم السلطة التنفيذيّة بهذا الدّور، فمفهوم النّظام السّياسي يمتدّ ليشمل قوى الأمن ورجال الأعمال المستفيدين من النّظام كما أوضحنا سابقاً.
تختلف التغيّرات السياسية في المجتمعات على مدى تأثيرها في تماسك مجتمعاتها، فمنها ما يعزّز الوحدة الوطنيّة نظراً للحالة الثورية التي يعيشها الشّعب. ومنها ما يترك آثاراً بالغة السّوء على الاندماج الوطني في حال لم يكن المعارضون للتغيير أو الثورة هامشيّين وكانوا مكوّناتٍ أساسيّةً من الشّعب، وقد يكون لذلك أسبابٌ تاريخية معينة [1]. ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما نجح التدخّل الخارجي في اختراق كلّ طرف، عندها حتّى لو أراد كلا الطّرفين التنسيق فيما بينهما، قد يعرقل ذلك المصالح الخارجيّة المتضاربة.
حافظت تركيا على علاقتها مع النظام السياسي في سوريا، ولو أنّها تراجعت عمّا كانت عليه، ولكنها في الوقت نفسه دعمت المعارضة السوريّة العلمانيّة والإسلاميّة بشكل فاق أيّ دعم تلقّته المعارضة من أيّ أطراف إقليميّة لا تنسجم مع سياسة النظام السوري الخارجيّة. كما تحاول تركيا أن تبنيَ أفضل العلاقات مع تونس وخاصّةً مع حركة النّهضة. وفي ليبيا شاركت تركيا إلى جانب قوّات الناتو في قصف قوّات القذافي ومقرّاته. وحتّى اليمن البلد الوحيد الذي لم يستطع العثمانيّون دخوله، أصبحت تركيا لاعباً مهماً فيه.
على الجانب الآخر، اعتبرت إيران ما يحدث في سوريا مؤامرةً غربيّة، وأبدت دعمها الكامل للنّظام في سوريا. واتّخذ العراق ،ممثّلاً في حكومة المالكي، موقفاً مسانداً للرئيس الأسد مع تأكيده على أهميّة الإصلاح السّياسي. وفي سوريا ما زالت الاحتجاجات إلى حدّ الآن مقتصرةً على طائفة واحدة تقريباً. أمّا في لبنان، فقد أعرب حزبُ الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحرّ والحزب التقدّمي الاشتراكي عن ثقتهم بالنظام السوري وقدرته على تجاوز الأزمة مع تأكيدهم على الرّغبة في الإصلاح السياسي.
من خلال ما سبق، نجد أنّ هواجس أزمة الهويّة، وإذا ما حملت مركّبات خارجيّة، هي هواجس مشروعة وخطيرة في تداعياتها قد تُؤدّي إلى مزيد من تفتيت انقسام المشرق العربي طائفياً وأقوامياً. لذلك يجب إيجاد حلٍّ سياسي للأوضاع في سوريا يضمن عمليّة تحوّل ديمقراطي بشكلٍ سلمي بعيدة عن أيّ تدخّل خارجي مَهْما كان. ومن ثمّ يجب أن تنجح الدول العربية الأخرى وخاصّةً مصر في تحوّلها الدّيمقراطي لكي تكون دولة قويّة تساهم بشكل فعّال في بناء نظام إقليمي عربي قادرٍ على مواجهة تحدّيات النظام الإقليمي ويتفاعل معه لا أن يخضع له.
ويتم ذلك بتنمية قدراتنا الذاتيّة وامتلاكنا آليّات التطوّر الذاتي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وتكنولوجياً، وذلك بما يعزّز الشّروط والمتطلّبات الذاتيّة المطلوبة لصيانة الأمن القومي العربي. وتقتضي التّنمية أن نتحرّك على أساس مصالحنا القوميّة، ونحدث توازناً معقولاً ومؤثّراً بين السّياسة الدفاعيّة والسّياستين الاقتصاديّة والسياسية.
تحضر العروبة بوصفها المفهوم الأكثر قدرةً على جمْع الهويّات الفرعيّة في إطار متجانس جامع لها دون أن يتعارض ذلك مع الانتماءات الوطنية، كما تستطيع أن تلبّيَ الهواجس الأمنيّة للدول العربية الصغيرة، وتوفّر للدول العربيّة الكبرى ما تحتاج إليه لتحقيق التنمية من خلال التعاون العربي في مختلف المجالات. ولكن شرط أن يتمّ ذلك في مناخ عام من الحرية والديمقراطية، لكي نضمن استمرار فعاليتها عن طريق آلية العمل الديمقراطي التي تُبعد مَن لا يستطيع تحقيق المصالح الوطنيّة العليا للدولة.
————————
[1] – أحمد يوسف أحمد: التحولات العربية والوحدة الوطنية، (31- مايو- 2011, جريدة الاتحاد، http://www.almogaz.com/news/128206 )
http://www.dohainstitute.org/release/e4ac4302-f617-4dbf-80db-cd3c0cfe9811
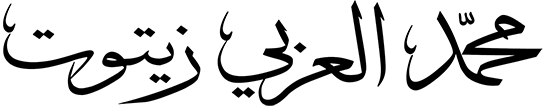


التعليقات مغلقة.