أزمة الحكم في الجزائر من مال السلطة إلى سلطة المال
في مقاله المنشور مؤخرا في جريدة «القدس العربي» الذي عنونه بـ»صراع أبناء المخزن الجزائري»، انتهى الكاتب السياسي والسوسيولوجي الجزائري ناصر جابي إلى رسم مستقبل مثقل بالإشكالات ينتظر المجتمع الجزائري.
موضحا «نحن إذن أمام صراع سياسي بأدوات متعددة اقتصادية وإعلامية، غير شفاف، يبقي المواطن بعيدا عنه، ينظر له كصراع بين أبناء المخزن نفسه». مركزا في تحليله على الأزمة التي وجد، أو أوجد النظام في الجزائر نفسه فيها، بعد أن انتج لوبيا استقوى عليه بعد أن كان يتقوى به، فما هي أسباب هزيمة الصانع أمام المصنوع؟ لاسيما أن الأفاق باتت جد ضيقة، مع اقتراب موعد رئاسيات 2019 وسط هذا الفراغ الفوقي والعزوف القاعدي عن كل مبادرة صارت تحمل عبارة «الاستحقاقات الوطنية»، وهو ما أبرقه الشعب للقادة والساسة بمقاطعته الكاسحة لمهزلة تشريعيات الربيع الفائت.
يكشف تاريخ نشوء السلطة في الجزائر عبر تجربة الحركة الوطنية، والصراع الدموي العنيف الذي عرفته من أجل «السلطة» عن قصة طويلة لهزيمة المتبوع من التابع، إذ في كل مرة يطاح بالسلطة من قبل حاشيتها، وهي تسعى بها لسحق خصومها المباشرين، وعودة مقتضبة لفترة المخاض الذي عاشته سلطة الثورة، حين تفجرت فيها سجالات الأوليات، مفضية إلى تمردات متتالية، وصلت إلى حد التصفية الجسدية، والاعتقال التعسفي والنفي، إذا كان صاحبه من ذوي الحظ الأعظم، عبر عنها الراحل محمد بوضياف، وهو يذكر لحظة اعتقاله من قبل قائد الأركان في فترة حكم أحمد بن بلة بالقول «سافرت إلى المسيلة لزيارة أهلي سنة 1964 فألقى عليّ القبض طاهر زبيري، اقتادني إلى الأوراس، ولما سألته عن السبب قال لي للاختلاف في التوجهات السياسية! فقلت له المسألة لا تتعلق بهذا الأمر مطلقا، فما هو حاصل هو أنك تمتلك قوة عسكرية وأنا لا أملك شيئا».
تعبير يجلي حقيقة الهزيمة المبكرة للسياسي التقليدي في الجزائر، المجرد من وسائل القوة أي قوة، إلى وقت الجزائريين هذا.
هكذا كانت تتطور السلطة في الجزائر مذ وعت نفسها ووعاها المجتمع، كطرفي نقيض لا يعبر بعضهما عن الآخر، لا ارتبطا ولا طموحا، إذ كانت القوة وإخضاع القوة سمة التعايش بين المجتمع والنظام، مع حرص تام من العديد من الأطراف، داخلية وخارجية، على أن يستمر هذا التعايش القائم على الاسترابة المتبادلة إلى حيث أمكنه أن يستمر. كيف تتطور السلطة داخل حركية نظام ليس له شكل ولا صورة وأصوله مبعثرة في خزانة الماضي الوطني؟ أو كيف تتغير داخل نسق ثابت تفرضه طبيعة ذلك النظام مبهم الهوية، الذي يجثم على مصير المجتمع ويحول دون نهضته للغدو نحو المستقبل بشكل طبيعي وسلس؟
في الحقيقة ارتبط وعي السلطة بذاتها باللحظة التي استلمت فيها المجتمع من قبضة الاستعمار، فهي تعي أن أي تخل عن نزعتها البطريركية، سيعني بالضرورة تضييعها للغنيمة الكبرى التي حصلت عليها بعد حرب ولايات قذرة عشية الاستقلال، وعليه صارت في سبيل إعادة إنتاج نفسها إلى السعي الدائم لإنتاج مجتمع مواز موال، يكون بمثابة العاكس بشكل غير حقيقي لطبيعة تطور المجتمع الجزائري العميق. فعوض أن ينتج الشعب مجتمعه السياسي وفق شرطيات التاريخ والطبيعي في ظروف التطور، راح النظام يستبقه في كل مرة إلى ذلك، بوضع نسق وهمي يشوش به على سير تطور الوعي، وامتلاك آليات ممارسته في الواقع، فبعد أن أنتج داخل المنظومة الأحادية هياكل وجمعيات وسمها هو بالشعبية، أعاد صياغة التعددية الحزبية بعد ثلاث سنوات من ممارستها الحرة والحقيقية، إلى ما يشبه «التعدد الأحادي»، إثر انقلاب 1992. أحزاب لا تؤمن بأصولها الشعبية، بل بحلم وصولها إلى القمة بجوار السلطة، مهما كلفها ذلك من تنازلات وتضحيات بالمصداقية.
بعد أن انتظر الجزائريون عقب الإقرار بالتعددية، رؤية ميلاد المجتمع السياسي الذي كانوا يأملون، صدموا برؤية «ميلاد مجتمع السلطة» ينمو ويكبر مع كل زعيم دق أبواب القصر.
إرادة التغيير داخل «الثبات» الذي اختطته كنهج لها سلطة النظام المتخفي، طالت عالم الإعلام لتشكيل الرأي العام وفق ذلك «المتغير الثابت» فبعد الردة عن التعددية الإعلامية النموذجية التي برزت مع دستور 1989 وكانت رائدة على الصعيد الإقليمي، اكتسحت السلطة من خلال لوبياتها هذا الفضاء متحكمة به بقوة الاحتكار الاشهاري، قبل أن تبادر من خلال غيلان المال الذين تربو ونمو في ظلمة البنوك العمومية إلى التأسيس لتعددية سمعية بصرية على المقاس قاطعة بشكل كلي مع وعي المجتمع بها.
فمرة أخرى يخيب أمل المجتمع في رؤية نفسه ينزاح تماما عن هيمنة ظل سلطة النظام، وتسقط تجربة التعدد السمعي البصري حتى قبل أن تولد بالشكل القانوني، حيث تكررت تجربة الخطاب التلفزيوني الأحادي سنوات المصادرة الكلية للوعي الوطني، وتجلت مصالح الأشخاص المرتبطين بالسلطة أكبر مستفيد من فتح الفضاء السمعي البصري على حساب مصالح المجتمع. لقد حرصت السلطة على أن يظل الاقتصاد طوع إرادتها لبسط نفوذها الدائم على المجتمع، وبالتالي الاستماتة والاستدامة لتظل جاثمة عليه، فالاقتصاد الجزائري كان ولا يزال «اقتصاد سلطة» وليس «اقتصاد أمة» تأسس أولا عبر خيار اشتراكي سمح لها بامتلاك كل وسائل الإنتاج، وبالتالي وسائل المال العام توظفه وفق تصوراتها وإرادتها، وهذا ما أشار إليه فرحات عباس في أحد كتبه، مؤكدا أن خيار الاشتراكية التي انتهجها نظاما بن بلة وبومدين لم يكن عن قناعة فكرية ولا سياسية لديهما، بل لأنه الخيار الوحيد الذي يتواءم مع الديكتاتورية والرغبة في الاحتفاظ بالسلطة».
ومع نهاية موضة الاشتراكية الشمولية طفقت السلطة في الجزائر تتغير في الشكل دون المضمون، بحيث واصلت الهيمنة على مصدر رزق الجزائريين، ممثلا في شركة سونطراك النفطية، مع إنتاج قطاع خاص هجين، خاص بها هي، يسير في فلكها وتحت عينيها، تكفي هنا عودة وجيزة للخلفية الاجتماعية لأصحاب المال اليوم الذين جيء بمعظمهم من سحيق أعماق المجتمع الجزائري، أي من الطبقة الضعيفة، ليحولوا إلى رجال أعمال بالمال العام ! يتجاوزون في أرقامهم المصرفية كبار رجال المال في العالم، في فترة عقد من الزمن، تكشف بحق دور السياسة في المال، قبل أن يعكس هذا الهجوم ويصبح هو الفاعل الأول في السياسة في الجزائر.
لكن كل تلك التجارب والتقلبات التي عرفتها السياسة في الجزائر، كانت قد جرت في ظل شكل ثنائي لرأس السلطة، الظاهر منه (الحكومة والجهاز التنفيذي) والباطن (جهاز الاستخبارات) ذلك الشكل الذي حاربه بوتفليقة واستطاع أن يحدث فيه شرخا جزئيا من خلال تعطيل دور المخابرات، لكن هاته الأخيرة ليست بالمصلحة المؤسسية العادية، التي تبدأ وتنتهي بقرار فوقي، تاريخيا كانت هي المؤسسة لعنف السلطة ثم لسلطة المال، كوسيلة قيادة المجتمع منذ بداية التسعينيات في ظل تلاشي سلطة الأيديولوجية التي كرسها خطاب دولة الاستقلال وانقبار حلم من أجل حياة أفضل! فالمال هو المحرك اليوم للعبة اللوبيات وجماعات الضغط داخل السلطة، كتعبير صريح عن خطورة الفراغات التي خلفها تغييب السياسي الحقيقي، والاستعاضة عنه بالاوليغارشية المصطنعة التي اصطف بعضها لهذا الجانب وبعضها لذاك، ما عسّر التكهن بطبيعة النهاية في معركة كسر العظم الحاصلة، واستعار معركة ما بعد بوتفليقة، في ظل صمت القبور الذي التزمته كعادتها ما تسمى بالمعارضة، وترقب الشعب بخشية دائمة على مصيره ومصير الوطن.
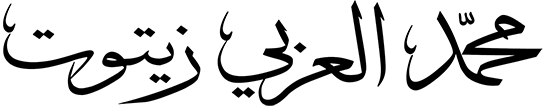



مال السلطةة الى سلطة المال
حاج موسى الى موسى الحاج