الثورة وسؤال اللاعنف | د. عبدالحسين شعبان
سألتني الأديبة والإعلامية نوال الحوار عن جدوى الحديث عن اللاعنف في ظل مجتمعات تنزلق إلى العنف بصورة مريعة، وتنفتح فيها شهيّة المتصارعين بلا حدود للإقصاء والإلغاء والإفناء، للآخر، الخصم، العدو، وأردفت بالقول أين مكان اللاعنفيين في ما تطلق عليه “الربيع العربي” حيث تندلع الثورات، ومثالي هو سوريا؟ وكان جوابي في برنامج “المشهد الثقافي” الذي تقدّمه، أن استمرار ظاهرة العنف ومن ثم العنف المضاد هما اللذان يجعلان من الدعوة للاعنف ضرورية وراهنية بإلحاح، خصوصاً أن ثقافة العنف هي السائدة، ويتطلّب الأمر تسليط الضوء على مخاطر العنف وردّ الفعل “ العنفي” عليه في ثنوية لا تنتهي، كأنها مصارعة على الطريقة الرومانية، بحيث يتم القضاء على أحد المتصارعين، في حين يصل الثاني إلى حدود الموت أيضاً، وهكذا سوف لا يكون أحد منتصراً وهو يمارس لعبة العنف التي ستحرق الجميع من دون استثناء . ثم من قال إن العنف ملازم للثورات بالمطلق؟ لنأخذ انتفاضة الحجارة الفلسطينية مثالاً بارزاً، فقد اندلعت في أواخر العام 1987 وأوائل العام 1988 وامتدّت لأعوام، من دون أن تتمكن “إسرائيل” من القضاء عليها، على الرغم من محاولات استدراجها للانخراط في ردّ الفعل لمواجهة العنف بالعنف، في ظرف مختل ويميل فيه ميزان القوى لمصلحة الصهيونية و”إسرائيل”، وهو الأمر الذي لم تنجرّ إليه الانتفاضة الفلسطينية آنذاك، حيث فوّتت الفرصة على “إسرائيل” لدمغ كل أعمال المقاومة والحق المشروع بالدفاع عن النفس بالإرهاب . وأتذكّر أنني بدعوة كريمة من السفير الفلسطيني في براغ سميح عبد الفتاح، العام 1988 ألقيت محاضرة عن “الانتفاضة الفلسطينية” . . بين السياسي والايديولوجي، وعندما وصلت إلى الحديث عن سمات الانتفاضة وخصائصها الجديدة ندّت همهمات من داخل القاعة، أقرب إلى الاعتراض أو حتى الاحتجاج تتساءل عن مدى انطباق أطروحاتي مع تعاليم ماركس ولينين حول شروط الانتفاضة وقيادتها .
وأقدّر الوقع الجارح على الذين لم يستوعبوا المتغيّرات، فاستمروا يفسّرون الظواهر طبقاً لبعض القوالب الجاهزة والتعاليم النظرية التي عفا عليها الزمن، حتى وإن كانت تصلح لزمانها، خصوصاً أن معطيات مختلفة تبلورت بين هذه وتلك، فما بالك ونحن نتحدث عن فلسطين تحت الاحتلال، والأمر سيزداد تعقيداً في الوقت الحاضر بشأن قيادة الانتفاضة وأساليب كفاحها وتكتيكاتها وقواها المحرّكة ودور الشباب، وأهمية الاعلام تعبوياً وتحريضياً وتنظيمياً في تواصلها واستمرارها، وهو الأمر الذي تفرضه العولمة بوجهيها المتوحّش والإيجابي، في ظلّ الثورة العلمية- التقنية وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصالات والمواصلات .
وإذا أردنا أن نتحدث عن حركة الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في العديد من البلدان العربية وقادت إلى تغيير أنظمة الحكم فيها فلا بدّ أن نأخذ المعطيات الجديدة في نظر الاعتبار، تلك التي تجلّت، على وجه الخصوص في تونس ومصر، فقد كان الخيار هو اللاعنف والمقاومة السلمية المدنية، أما في ليبيا فقد انطلقت الحركة الاحتجاجية وتوسّعت باعتبارها حركة سلمية ولا عنفية، لكنها تحوّلت لاحقاً كردّ فعل لعنف السلطات إلى عنف مقابل، ومن ثم تداخلها مع العنف الخارجي الذي قاده حلف الناتو، الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة بقضية التطوّر السلمي المدني، وبالطبع اللاعنفي اللاحق .
وفي اليمن، أجبرت الحركة الاحتجاجية اللاعنفية، الرئيس علي عبدالله صالح على التنحّي على الرغم من انتشار السلاح، حيث أسهم مجلس التعاون الخليجي في إنجاح عملية اتفاق مضنية، لا تزال بحاجة إلى تأمين مستلزمات نجاحها واستمرارها، لا سيّما أن هناك قلقاً لا يزال قائماً من الصدام المسلح وانفلات العنف الذي قد يجرّ وراءه عنفاً لبعض دول الجوار .
وكانت الحركة الاحتجاجية المدنية السلمية لا عنفية في سوريا، واستمرّت على هذا النحو ستة أشهر تقريباً، لكن العنف الذي مارسته السلطات بقمعها، دفع بعض أطرافها إلى الاستعانة بالعنف للمواجهة، وهكذا يستمر العنف والعنف المضاد من دون إمكانية التوصل إلى حلول سياسية ومقنعة، ويدفع الشعب الفاتورة عدّة مرات، في الأولى حيث يستمر قمعه وعدم الاستجابة لمطالبه السلمية، وفي الثانية حيث المجابهات المسلحة وتدمير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية الحيوية وما بناه بسواعده وعرقه على مدى عقود من الزمان، وفي الثالثة حيث يستمر الحصار الاقتصادي عليه مدمّراً نسيجه الاجتماعي، وفي المرّة الرابعة حيث تلوح في الأفق احتمالات استمرار الحرب الأهلية التي قد تؤدي إلى تفتيت البلاد وتشطيرها، من دون التمكّن من حماية المدنيين وتأمين احترام حقوق الإنسان . وفي المرّة الخامسة ما سيتركه العنف على المجتمع من تأثيرات خطرة، ولعلّ التجربة العراقية خير مثال على انزلاق العنف وشموله فئات الشعب كافة .
ولهذه الأسباب يعدّ البعض أي حديث عن اللاعنف إنما هو أقرب إلى “البطر الفكري” أو رغبة في إسقاط الأفكار على الواقع أو محاولة لتجسيد بعض المثل العليا في بيئة لا تصلح لها، أو حتى يعدّه في أحسن الأحوال نوعاً من “الهذيان الفلسفي” .
لكن وقائع التاريخ البعيد والقريب فيها الكثير من الأمثلة للإجابة عن السؤال الذكي عن الثورة واللاعنف، ولنأخذ مثالين آخرين من منطقتنا بعد مثال ثورة الحجارة الفلسطينية . الأول هو نجاح الثورة الإيرانية في العام 1979 باللاعنف، بعد حركة احتجاج استمرت بضعة أشهر، وبعد تطوّر أساليب المقاومة اللاعنفية، حيث اضطرّ شاه إيران إلى الرحيل وأطيح النظام، والثاني هو الحركة الاحتجاجية الواسعة التي بدأت في لبنان في العام 2005 التي اضطرّت بعدها القوات السورية إلى الانسحاب بعد وجود استمر نحو 30 عاماً .
أما الأمثلة من خارج المنطقة فهي كثيرة أيضاً، حيث كانت لحظة انهيار جدار برلين ،1989 إيذاناً بوضع حد فاصل بين مرحلتين، ونجحت ثورات أوروبا الشرقية جميعها تقريباً باللاعنف، عدا بعض استثناءاتها في رومانيا، أو في ما بعد خلال حروب يوغسلافيا وانقساماتها، أو عند تفكّك الاتحاد السوفييتي والحروب التي أعقبته، لكنها كانت ثورات لا عنفية بامتياز، وقد تحاقبت مع بعض التغييرات في أمريكا اللاتينية بواسطة اللاعنف، وأحياناً كانت الثورة تمرّ عبر صندوق الاقتراع كما عكست الانتخابات في نيكاراغوا وفنزويلا وتشيلي والإكوادور والبرازيل .
ولعلّ هذا واحد من التغييرات التي حصلت في مفهومنا للثورة، فهي ليست بالضرورة عملية عنفية، أو تشترط أن يكون وراء كل ثورة أو حتى حركة ثورية “نظرية ثورية”، وهو ما كنّا نردّده لعقود من الزمن، وقد كشف لنا الواقع إمكانية “الانتصار باللاعنف”، مثلما انتصرت حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، والحركة المناهضة للتمييز العنصري في جنوب إفريقيا، بل أصبح اليوم بإمكان قيادات ثورية شابة ومن خلال التواصل الاجتماعي، إنجاز مشروع الثورة، إذا ما توفّرت الشروط الموضوعية والذاتية لذلك، وانتفت الحاجة إلى ما سُمّي “العصبة الثورية” لقيادة العمل الانقلابي في جنح الظلام، والتخطيط له سرا وعبر أوكار حزبية، فالعالم تغيّر وأساليب الكفاح تطوّرت .
ومهما ارتبطت الثورات تاريخياً بالعنف باعتباره “قاطرة التاريخ” على حد تعبير ماركس، ومهما كان العنف متأصلاً في المجتمع، الاّ أن السلم والتطوّر التدريجي، يظلاّن الهدف المستمر لأي تغيير ثوري، وبهذا المعنى ستكون الثورة حالة مؤقتة، بل وحتى عابرة، وسيكون وليدها “ التاريخي” الذي ارتبط بها أي العنف “ مؤقتاً” أيضاً، ولن تزدهر الحرية الاّ بالسلم، وهكذا، فالثورة ليس بإعلان مجابتهما للأنظمة القائمة، ولكن بقدر استمرارها وتحقيقها أهدافها، ولاسيما الحرية والعدالة الاجتماعية .
وبهذا المعنى سيكون اختيار اللاعنف لتفجير الثورات عملية خيار واعٍ لجوهر ومحتوى الحرية، استباقياً، باختصار الطريق للوصول إلى “مملكتها”، ذلك أن انفلات العنف سيؤدي إلى التجاوز على القوانين والأنظمة، ويفتح الغرائز لشهيّة المتصارعين في استئصال أحدهم الآخر، وإذا كان العنف بالقانون “مقنناً”، فإن انفلاته مجتمعياً سيكون بلا حدود، وخطراً يهدّد السلام والحرية وقيم الثورة ذاتها وفلسفتها . وسيكون من أولى واجبات الثورة تقنين العنف وحصره بالدولة تحديداً لإمكانية تحقيق المساواة والعدالة والتنمية واحترام الحقوق الإنسانية . ويعرف غاندي بأنه مؤسس المقاومة السلمية “الساتياغراها” التي تقوم على ثلاثية الشجاعة والحقيقة واللاعنف، وقد انتصر باللاعنف على “بريطانيا العظمى” أعتى امبراطورية في العالم في حينها عبر الإضراب عن الطعام والمقاطعة والاعتصام وصولاً للعصيان المدني حتى تمكن من إلحاق الهزيمة بالاحتلال وتحقيق الاستقلال . وأخيراً، يمكن القول إن اللاعنف لا يعني السلبية أو الضعف، وحسب غاندي أنه أعظم قوّة متوفرة للبشرية . إنها أقوى سلاح صنعته براعة الإنسان .
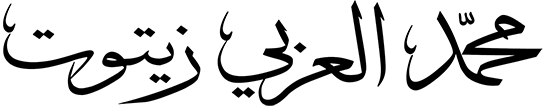


التعليقات مغلقة.